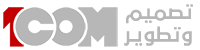كانت أسوار بدر الدين الجمالي، التي كانت تحتمي بجدرانها المدينة القديمة، قد تحررت المدينة من قبضتها، وانسلخت من أسرها، فانطلقت متجاوزة حدودها، وتمددت، وترهلت وساحت فيما يحيطها من فضاءٍ لا منتهٍ، تاركة إياها تجتر ماضيها وحدها، وضجيج السيارات وصخب المَّارة ينهش في سكونها وصمتها الطويل، بينما تنخر في أساساتها رطوبة الأرض، وينال من هيبتها الصبية الذين يتنازعون امتلاك الكرة في الساحة المتاخمة لها.
أسير معها، أتأملها من بعيد، وهي ترتفع شاهقة وقد عادت لها الحياة، ولم يعد لها ما كان لها من مكانة ودور. أستدعي أيام مجدها وهيبتها، يستغرقني الاستدعاء حتى يستقبلني باب الفتوح، المفتوح للمارّة والمركبات نهاراً وليلاً، منتصباً شامخاً كما كان، بينما تقاعست جيوش الفتوحات عن الخروج منه لغزو وفتح. ألقيت السلام على سيدي "الذوق"، الساكن في هدوء في ركن الباب الكبير كأنما يستجير به من الناس أو يجد الأنس في جواره.
طالعني جامع "الحاكم بأمر الله" بواجهته الحجرية العالية الكبيرة التي تزينها الشرفات المسننة، ومآذنه التي تأخذ شكل المباخر من بعيد، اتخذ الزوار من ساحته الخارجية، مُتنَزهَاً، ومطعماً، ومقهى، ومسرحاً لالتقاط الصور الفوتوغرافية. عانيت الكثير، أيها الجامع الكبير، ولا زلت تعاني، في كل ركن أو موضع في الساحة الكبيرة، التي تجاهد الأشجار أن تشارك البشر والمقاعد فيها، يتعثر نظري بمن يُصوَّر أو يُصوِّر، تلبَّس القوم هوسٌ مستعرٌ بالتصوير .. لا أدري سبباً له ولا أجد مبرراً له؟
لماذا يبدو الناس أمام كاميرات التصوير مثاليين، يحرصون على الظهور في أبهى صورة، يبتسمون دائماً، ينسون الدنيا ومشاكلها، وما فيها ومن فيها، إلا من يشاركهم الحدث، ثم سرعان ما تذوب ابتساماتهم وتختفي بمجرد التهام اللحظة الخاطفة، لمن يثبتون أنهم سعداء؟!.
أخذتني قدماي إلى حيث الشارع الكبير، وقد خلع عنه ثيابه البالية، واسترد عافيته، وارتدى نعلاً من الصخر المصمت القاسي، وهو لا يزال على عهده يصارع الزمن، مخترقاً المدينة القديمة المتخمة، في ثباتٍ وشبه استقامة، من باب الفتوح شمالاً إلى باب زويلة جنوباً، بمبانيه الشاهقة الصامدة، ومآذنه السامقة، وحوانيته الضيقة، بينما أزقته وحاراته المرهقة، التي تتشعب منه يميناً ويساراً أو تصبُّ فيه، تلفظ ما في أفواهها في جوفه الذي يعجُّ بخليط من البشر، رجالاً ونساء، شباناً وفتيات، يتسكعون في رحابه، أو يجلسون على مقاعد خشبية على جانبيه، يغشون متاجره الضيقة، أو يستوطنون مقاهيه المبعثرة هناك أو هنا، وقد تزينت لاستقبالهم، يتسامرون، يضحكون، يأكلون الحلوى، يوثقون ذكرياتهم المولعون بالتقاطها، بينما تعلو وجوه الشباب والفتيات ابتسامات، وتتوهج ضحكات، فهذه ترتدي ثوب بدوي أو أخرى تأخذ وضع تصوير وهي ترتدي عباءة بلدية مزيَّنة بالخرز الملون اللامع، وثالثة مشغولة برسم وشم من الحناء على يديها، ورابعة يرتاح ذراعها على ذراع شاب فارع عريض ويعبران الشارع يقتسمان الضحكات، ودرَّاجات بخارية لا تكف عن الصياح والهرولة، بينما ينساب صوت أم كلثوم في تحسرٍ وشجن: "وعايزنا نرجع زي زمان.. قول للزمان ارجع يا زمان"..
بات واضحاً أن القوم لا يعيرون اهتماماً لتحذيرات منظمة الصحة العالمية، ولا وزارة الصحة، وطنين وسائل الإعلام المتواصل عن مخاطر انتشار الوباء، ولا لوجوب أخذ الإجراءات الاحترازية، ومراعاة ارتداء الأقنعة والحرص على التباعد، كأنما لا يوجد وباء، أو كأن القوم قد صادقوا الوباء أو صادقهم الوباء. كان الصخب والضوء يطارداني خطوة بخطوة، من متجر لمتجر، ومن مقهى لمقهى ومن زقاق لزقاق.
جاءت إقامة صلاة العشاء من بعيد بصوت خافت يجاهد الصخب الطاغي والأصوات المختلطة، عدت أدراجي لجامع "الحاكم" الكبير، أحب الصلاة في المساجد الجامعة، وخاصة العتيقة منها، اشتم فيها رائحة الماضي، واستشعر فيها الهدوء النفسي، والصفاء الروحي، كانت الأضواء الملونة المنبعثة من مصادرة في الأرض تزين جدرانه الحجرية العتيقة، توجهت لمدخله الكبير المرتفع، أعلاه كانت الإضاءة قد كشفت عما فيه من زخارف وكتابات، لفت نظري وجود سيدة منتقبة قد انزوت في ركن ملاصق لمدخل الجامع اتخذته مكاناً لمصلاها. خلعت حذائي وحملته في يدي، ودلفت من الباب الكبير المفتوح الذراعين، كان القمر يعلو الشرفات الحجرية المسننة المرفوعة الرأس فوق رواق القبلة، ويبسط أشعته في ساحة صحنه المتسع ذي الأرضية الملساء، الذي خلا من مرتاديه، اتخذت مكاني في صفوف المصلين قليلة العدد، كانت الأضواء خافتة وكان الهدوء يبسط سطوته على المكان، سوى صوت الإمام الذي انساب في أرجاء المكان رائقاً، صليت ما شاء الله لي أن أصلي من صلاة التراويح، ويممت وجهي صوب باب للخروج، حتى إذا ما انتعلت حذائي وتجاوزت كوة المدخل، كدت اصطدم بشاب فارع عريض يضع يده على كتف أنثى تلف ذراعها حول وسطه، يتوسطان مدخل الجامع العتيق ويتهيأن لتخليد لحظة رومانسية، كان المصور الفوتوغرافي منهمكاً في الإعداد لها وتوثيقها، وخلفهما كان باب الجامع العتيق يفتح ذراعيه صامتاً، وعلى أحد جانبيه كانت لا تزال السيدة المنتقبة منزوية في مصلاها، بينما الساحة الكبيرة المضيئة بالخارج لا تزال صاخبة مضيئة تعجُّ بالبشر.